
بقلم: الصحافي أمين بوشعيب/ إيطاليا
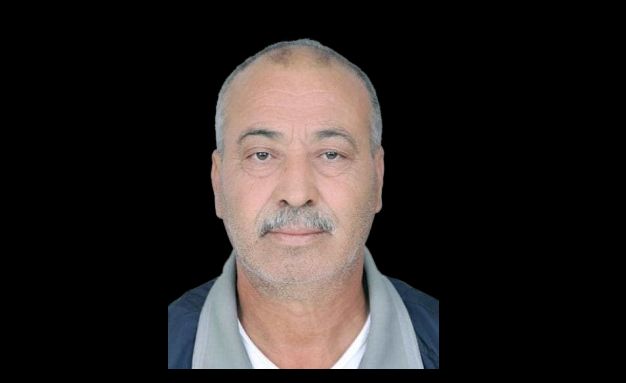
بالأمس حلّ عيد العمال في المغرب، وهويحمل معه تساؤلات حارقة حول واقع الطبقة العاملة وآفاقها، تساؤلات تعبّر عنها ببلاغة مريرة أبيات المتنبي، وأشهرها قوله: “عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ؟”، وكأنّ الشاعر يخاطب هذا العيد نفسه، الذي يأتي محمّلاً بخيبات التكرار بدل بشرى التجديد.
منذ عقود، والطبقة العاملة في المغرب تخرج في مسيرات وتظاهرات، رافعة شعارات تطالب بالكرامة، والعدالة الاجتماعية، وتحسين الأجور وظروف العمل، ومحاربة الهشاشة والتعاقد المؤقت، وضمان التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. ورغم الوعود الحكومية والتزامات الحوار الاجتماعي، لا تزال الفوارق الطبقية تتسع، والمعاناة اليومية تتكرّر.
في هذا السياق، يبدو عيد العمال أشبه بمرآةٍ تعكس آلام الشغيلة أكثر مما تحتفي بإنجازاتهم. فهل عاد العيد بما مضى من المطالب المتكررة؟ أم فيه تجديد حقيقي في السياسات العمومية تجاه العمل والعمال؟
إن الاحتفال بعيد العمال يجرنا بالضرورة إلى الحديث عن القطاعات الاجتماعية الأساسية، حيث نلاحظ أن هذه الأخيرة قد عرفت تحولات ملحوظة في تدبيرها، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. هذه التغييرات، التي توصف أحيانا بـ”تفكيك” القطاعات الاجتماعية، تثير جدلا واسعا بين من يعتبرها إصلاحات ضرورية، ومن يراها ضربا لأسس العدالة الاجتماعية والدولة الراعية.
وإن من أبرز مظاهر هذا “التفكيك” تكمن في تزايد دور القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة. فرغم الجهود الحكومية لتعزيز الخدمات العمومية، فإن الأرقام تشير إلى تصاعد الاعتماد على المدارس والمصحات الخاصة، مما يكرس الفوارق الاجتماعية بين الفئات القادرة على تحمل كلفة هذه الخدمات وتلك التي تعتمد على القطاع العمومي.
وقد أدى ذلك إلى تراجع ثقة المواطن في جودة التعليم العمومي والخدمات الصحية المجانية، في ظل نقص الأطر والتجهيزات، وضعف البنية التحتية، الأمر الذي يدفع العديدين نحو الخيارات الخاصة رغم كلفتها الباهظة.
وأما في برامج الدعم الاجتماعي فقد أطلقت الدولة برامج مهمة، مثل نظام “تيسير”، و”راميد”، وصندوق دعم الأرامل، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية، لكنها ظلت تعاني من محدودية في الاستهداف وضعف الحكامة، ما دفع الحكومة مؤخرا إلى إعادة النظر فيها ضمن مشروع “السجل الاجتماعي الموحد”.
غير أن هذه الخطوات، وإن كانت تروم تحسين نجاعة الدعم، تُواجه بانتقادات حول احتمال تقليص الأثر الاجتماعي المباشر، خصوصاً إذا اقترنت بسياسات تقشفية تُفرض ضمن توصيات المؤسسات المالية الدولية.
وهو ما جعل بعض النقابات العمالية توجه أصبع الاتهام إلى الدولة بانتهاج سياسة انسحاب تدريجي من أدوارها الاجتماعية، مما يفتح المجال أمام تسليع الخدمات الأساسية وتحويلها إلى امتيازات لمن يستطيع الدفع، بدل أن تكون حقوقا مكفولة لجميع المواطنين.
في المقابل، ترى الحكومة أن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة تضمن الكفاءة والعدالة وتحد من الهدر، خصوصا في ظل الموارد المحدودة والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
لكن يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو التوفيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتثبيت العدالة الاجتماعية. فالرهان اليوم لا يكمن فقط في تأهيل القطاعات الاجتماعية تقنيا، بل أيضا في ضمان ولوج عادل ومتساوٍ لجميع المواطنين، بما يعزز ثقتهم في الدولة ويعطي للعدالة الاجتماعية بعدا فعليا لا شعارات فقط.
فلاش: إن عيد العمال يجب ألا يكون مجرد مناسبة رمزية، بل محطة لتقييم السياسات، والاستماع الحقيقي لصوت العمال، والاعتراف بدورهم الحيوي في بناء الاقتصاد الوطني. فلا معنى لعيد يُحتفل به بينما يظل العامل حبيس الهشاشة والتهميش.
وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحًا كما طرحه المتنبي منذ قرون:
“أبِما مضى أم بأمرٍ فيك تجديدُ؟”
والجواب مرهون بصدق الإرادة السياسية، وفعالية النقابات، ونضج الوعي الجماعي بأهمية إنصاف من يبنون الوطن بصمت.

